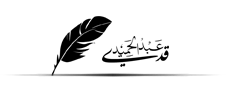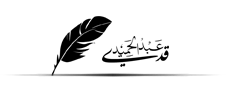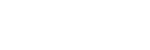ليتني كنت مجرمًــا اتصال هاتفي
اتصال هاتفيبينما كنتُ منهمكا في أشغال البستان إذ تلقيتُ اتصالا هاتفيا من صديقي، مختصر المكالمة أن أحد الصحفيين ينتظرني أمام المنزل وعليّ ملاقاته حالا!
بدا الأمر لي غريبا بعض الشيء، فماذا يريد مني الصحفي؟، انطلقتُ نحو المنزل بخطى متسارعة لأجد أحدهم واقفا هناك أمام سيارته ويحمل معه محفظة صغيرة، أدركتُ أنه الصحفي الذي يسأل عني، فملامحه توحي بأنه ليس من مدينة أولف، بادرته بالسلام ليرد هو الآخر بمثل ما قلتُ وزيادة، ثم أخرج من جيبه بطاقته المهنية وقدّم نفسه على أنه الصحفي عمّار .ث من جريدة وطنية مشهورة، وأخبرني أنه سمع الكثير عن مشاريعي الأدبية (قصص قصيرة، روايات، مقالات) وتحرّى عنها وتابع بعضها من خلال صفحتي على الفيس بوك، فأُعجِبَ كثيرا بها وقرّر أن يسجل معي حوارا مطولا حول مشواري الأدبي ومشاريعي المستقبلية...
كنتُ أنصتُ له بشعور مختلط بين الاستغراب والذهول والفرحة، لأن أعمالي الأدبية لا ترقى في اعتقادي إلى هذا الاهتمام من قِبَل جريدة كبيرة، وما إن أكملَ حديثه حتى رحّبْتُ بالفكرة ودعوتُه لدخول المنزل من أجل شُرب شيء، غير أنه كان على عجلة من أمره، فاعتذر بلباقة وركِب سيارته وأدار المحرك، ثم أخبرني أن موعدنا مساء الغد في أحد المقاهي المعروفة، وطلب مني رقم هاتفي ونصحني بجلب ثياب جميلة من أجل الصور التي سترفق مع الموضوع.
 إعلان حالة الطوارئ
إعلان حالة الطوارئما إن ذهب الصحفي بسيارته حتى ازدحم عقلي الصغير بعشرات الأفكار: موعد مساء الغد، المقهى، مسيرتي الأدبية، ملابس جميلة، مقال في جريدة وطنية... لم أعد أدري ما أفعل ولم أكن في وضع يسمح لي بوصف ما أشعر به، عدتُ سريعا إلى البستان لتكملة بعض الأشغال الصغيرة وتفكيري كله مُنصَبٌّ حول موعد الغد، لأنه عليّ أن أحضّر كثيرا لهذه المقابلة، وكيف لا وهي فرصة ذهبية وقد لا تتكرر.
فور عودتي للمنزل مجددا بحثتُ عن جميع أعمالي الأدبية التي أنهَكَتْ آفاتُ الزمن بعضَها، وبحثتُ أيضا في حاسبي المحمول عن كل مقالاتي ومنشوراتي وقصصي ورواياتي، ورُحْتُ أصنّفها واحدة واحدة، فهذه بداياتي مع القصة، وتلك لما كنتُ في الجامعة، والأخرى كتبتُها لما تعرضتُ للموقف الفلاني... المهم، قضيتُ حوالي ثلاث ساعات وأنا أجردُ وأبحثُ وأصنّفُ حتى أُقدِّم كلاما مفيدا من أجل مقابلة الغد.
بعد أن جمعتُ شتات عدة سنوات من أعمالي المبعثرة هنا وهناك، أبحرتُ في الأنترنت باحثا عن فن التعامل في مثل هذه الحالات، فقرأتُ مواضيعا متنوعةً عن ايتيكيت الحوار، وفنون الإقناع والتأثير، كما حفظتُ مقولات أدبية عالمية من أجل استعمالها، كما لم أغفل عن التنقيب على تاريخ الأدب وفنونه وأهم الفاعلين به منذ عهد سقراط مرورا بالعصر الجاهلي والعباسي ووصولا إلى أدبنا المعاصر، كذلك راجعتُ تعريفات القصة والأقصوصة والرواية وكذا المقالات وأنواعها وعناصرها وطرق تحريرها، ثم قمتُ بتحميل مجلات وجرائد عالمية ورحتُ أتفحصُ صور الشخصيات بها، طريقة جلوسهم، وابتسامتهم، ووضعية كل عضو في جسدهم، كما دقّقتُ في لباسهم من حيث طبيعته، والألوان وتناسقها وسرحات الشعر المناسبة حتى كوّنتُ فكرة شاملة كيف أبدو مساء الغد وماذا أقول.
 ربطة العنق التي غسَلَتْ ماء وجهي
ربطة العنق التي غسَلَتْ ماء وجهيبعد التحضيرات المكثفة للقاء، جاء الدور على اختيار الملابس، فبعد اطّلاعي على النمط المناسب لي في الأنترنت، ذهبتُ لخزانة ملابسي وقلبتها رأسا على عقب واخترتُ أجمل ما عندي ثم قمتُ بغسله – رغم أنه مغسول – وبعد أن يبس قمتُ بكيّه ثم وضعتُه جانبا، وهنا أصبح كل شيء جاهزا إلا مشكلة صغيرة كبيرة! إنها ربطة العنق، فأنا لا أملك ربطة عنق.
فكّرتُ مطولا أين أجد ربطة عنق، فجميع أصدقائي لا يملكونها، ولم يتبق سوى خيار واحد، وهو مرّ كالعلقم، عليّ أن أستعيرها من عندِ عدوِّ طفولتي، هو من أقراني ويسكن غير بعيد من بيتنا وقد تخرّجَ حديثا من الجامعة وسمعتُ سابقا أنه اشترى ربطة عنق من أجل حفل تخرجه.
ترددتُ كثيرا في الذهاب إليه، فهو لم يُعجبني يوما – وشعوره متبادل معي – ولكنني تشجعتُ وقررتُ الذهاب، فموعد الغد يستحق التضحية، مشيتُ حتى وقفت بباب منزلهم وطرقتُه، وما هي إلا ثواني حتى فتحتْ أخته الصغيرة البابَ، فسألتُها عن أخيها إن كان بالمنزل فقالت لي أنه يأكل الطعام، فطلبتُ منها أن تناديه فدخلتْ مسرعة وهي تصرخ "خويا خويا أراهو جاك حميد"، وقفتُ أنتظر عند الباب، مرّتْ دقيقة، دقيقتان، خمس دقائق، بدأتُ أتضايق، عشر دقائق، أين هذا الكائن؟ وماذا يفعل؟ كيف يتركني أنتظر كل هذه المدة؟ فكرتُ بالعودة لمنزلنا فيبدُو أنني شخص غير مرحب به – بل مؤكد – ، وما إن هممتُ بالرحيل حتى سمعتُ أصوات أقدامه تقترب من الباب، ثم خرج إليّ وهو ينزع اللحم من بين أسنانه – كم هو معتوه – ثم قال لي بنبرة أكرهها: "اتفضل واش عندك؟"، تمالكتُ نفسي على مضض وطلبتُ منه ربطة العنق من قبيل الاستعارة وليوم واحدٍ، فرد عليّ بتعالٍ: "واش باغي بيها"، أخبرتُه السبب، فقال لي بوجه عبوس: "علاه واش فرض تلبسها، البس نورمال وصاااااي"، وحينها ندمتُ على اللحظة التي فكرتُ فيها بالذهاب إليه، ثم أضاف قائلا: "اصبر دوك نجيبها"، دخل لمنزلهم ليأتي بها وأنا في وضع لا أحسد عليه، فقد قدّمتُ نفسي لقمة سائغة له وهو الذي يحاول النيل مني منذ الصغر، رجع مجددا وهو يحمل ربطة العنق وقدّم لي محاضرة في طريقة لبسها والمحافظة عليها وسرَدَ عليّ قصة شرائها وَبِكَمْ ابتاعها، ثم أوصاني مطولا حتى كرهتُ ربطة العنق وكل ما له صلة بربطة العنق، كظمتُ غيظي وصبرتُ على كلامه ومحاضراته – ولا أدري كيف استطعتُ ذلك- وأخذتُ ربطة العنق وعُدتُ لبيتنا وأنا مُهان.
في الليل لم أنم حتى وقتٍ متأخر وأنا أفكر في موعد الغد، وفي حماقتي التي قمتُ بها من أجل استعارة ربطة العنق، حتى خلدتُ للنوم وأشرق صباح اليوم الموعود.
 يوم المقابلة
يوم المقابلةفي الصباح وكعادتي قمتُ ببعض الأعمال الروتينية وفِكري مشغول بالموعد وبما حضّرتُه بالأمس، كما كنتُ أنتظر المساء بفارغ الصبر، وبعد صلاة العصر مباشرة أخذتُ حماما خفيفا وقمتُ بتغيير ملابسي ومشط شعري ولبستُ ربطة العنق السخيفة وحملتُ معي أعمالي الأدبية وتدرّبتُ جيدا على العبارات التي أقولها، وفجأةً رنّ هاتفي، إنه رقم جديد، لعله الصحفي، أجبتُ على المكالمة وكان فعلا هو، سألني عن مكاني فأخبرته أنني سأكون عنده بعد لحظات، ثم خرجتُ مسرعا للمقهى، وعند وصولي هناك وجدتُه قد حجز طاولة وبرفقه رجل آخر، رحّب بي وطلب مني الجلوس ونادى على الخادم أن يأتي بالعصير، ثم قدّم لي صديقه فارس وأخبرني أنه مصور يعمل معه لصالح الجريدة، وبعد التعارف وشُرب العصير طلب مني أن أركب السيارة للذهاب إلى مكان هادئ قصد تسجيل الحوار، وهو ما حدث، فذهبنا إلى أحد واحات المدينة أين جمال الطبيعة وهدوء المكان، فنزلنا من السيارة واخترنا موقعا مناسبا، ثم أخرج عمّار مسجل صوتٍ وورقة وقلما وبدأ يطرح عليّ الأسئلة وأنا أجيب مستغلا تحضيراتي الجيدة.
قضينا قرابة ساعة كاملة في الحوار، كانت ناجحة إلى حد بعيد، حيث استطعتُ من خلالها تقديم معلومات مرتبة وواثقة، كما طبّقتُ فنون الايتيكيت والإقناع، واستشهدت من خلال حديثي بمقولات عالمية وأحداث تاريخية وعرضتُ عليه جميع أعمالي منذ صغري وحتى الآن و... حتى أن عمّار انبهر بحديثي ولم يستطع إخفاء إعجابه بي.
بعد نهاية الحوار طلب مني عمّار أن أجهّز نفسي لأجل أخذ الصور الفوتوغرافية التي ستُرفق مع الموضوع، فأخبرتُه أنني جاهز، وهنا أخرج فارس كاميرا احترافية من السيارة ثم نظر بتمعن إلى المكان وقال لي: "قف هنا أمام هذه الشجيرة"، وكان الانتقاء رائعا، أخذ فارس الكاميرا وراح يُغيّر إعداداتها ثم صوّب الكاميرا باتجاهي وراح يطلب مني تعديل جسمي، فمرّة يذكر لي الإضاءة، ومرة أخرى الزاوية، وحينا يطلب مني ابتسامة صادقة.. حتى أخذ لي العديد من الصور من زوايا متعددة وبوضعيات مختلفة حتى ظننتُ نفسي للحظة أنني طه حسين.
مع اقتراب غروب الشمس كنا قد أنهينا الحوار والتصوير، شكرني عمّار وأخبرني أنه سَعِد بإجراء الحوار معي، بادلته المجاملة ثم سألته عن تاريخ نشر الحوار، فقال لي: "على أقصى تقدير 48 ساعة"، ركبنا السيارة وأوصلني عمّار حتى باب منزلنا، شكرته كثيرا وودّعته، ودخلتُ منزلنا والسعادة تملأ قلبي، حتى أنني ذهبت لعدو طفولتي وأرجعتُ له ربطة عنقه وشكرتُه شكرا حارا جعله يستغرب كثيرا.
 الحيّ كله يعرف
الحيّ كله يعرفبعد عودتي لمنزلنا أخبرتُ والدَيّ وإخوتي بما حدث، وطلبتُ منهم بحماسة أن يترقبوني بعد يومين في مقال خاص في الجريدة، ثم فتحت حاسبي المحمول ووضعت منشورا في الفيس بوك: "ترقبوني بعد يومين في حوار خاص في جريدة.....".
قبل أن أنام شرَدَ ذهني بعيدا، ورُحتُ أتخيل شكل المقال الذي سيُنشَر، هل سيضعون صورتي في الصفحة الأولى للجريدة ويكتبون بالبند العريض عني؟ هل سيخصصون الصفحات الوسطى للجريدة والتي تكون ملونة من أجل الحوار والصور؟ خصوصا وأن المعلومات التي أخذها عمّار تكفي لملء أربع صفحات وزيادة... وأنا أفكر وأفكر حتى انقطعتُ عن عالم الأحياء.
في اليوم الموالي أخبرتُ من التقيتُ من أصدقائي وسعادتي لا توصف، فما أجمل أن تتقاسم سعادتك مع الآخرين، تلقيتُ اتصالات هاتفية من أصدقاء شاهدوا المنشور على الفيس بوك، كما تلقيتُ أسئلة عديدة من قِبَل العائلة والجيران والأصدقاء، فما حلّ الليل إلا وكل الحيّ ينتظر صدور نسخة الغد من الجريدة التي سأظهر فيها، وأنتم تعرفون أن سرعة انتقال الأخبار أكبر من سرعة الضوء.
 موعد النشر
موعد النشرالساعة تشير إلى الواحدة ليلا وأنا مستيقظ أنتظر نزول الجريدة على الأنترنت، أقوم بتحديث الصفحة مرارا وتكرارا، وبعد مدة طويلة نزلت النسخة، قمتُ بتحميلها ثم فتحتُها بشغف، الظاهر أنني لستُ على صدر الصفحة الأولى، رُحتُ أقرأ عناوينها الرئيسية: المنتخب الوطني، ايبولا، إضراب، داعش، مراجعة الأجور، حادثة اغتصاب، حادث مرور، ضبط مخدرات.... لا يوجد شيء في الصفحة الأولى، واصلتُ قراءة الجريدة صفحة صفحة، حتى رُكن الثقافة ليس فيه شيء، بل الجريدة لم تنشر عني أيّ شيء، ذهبتُ للنوم وأنا أطمئن نفسي وأقول: "لعلهم ينشرونه غدا".
جاء الغد وأصبح كل من يلتقي بي يقول لي: "ما كان والو حميد، قرينا الجريدة كاملة"، وأنا أقول لهم: "ينشروها غدوا إن شاء الله"، حتى كثُر عليّ السؤال من الأصدقاء وكل من أعرفهم في الحيّ، فقرّرتُ الاتصال بعمّار حتى أطمئنّ، ردّ عليّ عمّار فسألتُه عن أمر نشر الحوار، فقال لي أن مسؤول التحرير بالجريدة قرّر أن يؤجل نشره ليوم الغد، وهنا تنفّستُ الصعداء وأخبرتُ الجميع بثقة بأن موعد النشر تأجّل ليكون في الغد.
وعند الواحدة ليلا تكرر نفس الأمر، نزلت الجريدة ولا يوجد شيء! كيف ذلك؟ لا أصدق. ومن شدة حسرتي وغضبي أخذتُ الهاتف واتصلتُ بعمّار في ذلك الوقت المتأخر، رنّ الهاتف ولا يجيبُ، قلتُ في نفسي: "غدا صباحا أعيد الاتصال به"، وذهبتُ للنوم وأنا في حال سيئة.
في صباح اليوم الموالي أعدتُ الاتصال بعمّار ولكنه لا يجيب، أعدتُ المحاولة مرتين ولا يجيب، وفي الثالثة أقفل عمّار هاتفه ليستقبلني الموزع الصوتي للهاتف: "إن الاتصال بمراسلكم...".
ماذا أفعل؟ ما العمل؟ قضيتُ اليوم بأكمله ولم أخرج للشارع إلا خفية مخافة أسئلة الناس، وأقفلتُ هاتفي ولم أدخل للفيس بوك لنفس السبب، حتى قررتُ أن أنسى الموضوع نهائيا وأن أتعامل مع الناس على أن الصحفي قد كذب عليّ وأن الموضوع لن ينشر، وكم كان صعبا هذا القرار.
في اليوم الموالي لم أترقّب الجريدة وتلقيتُ سخرية الناس وتهكمهم بصبرِ جمل، وقد سمعتُ ألوان "التمعناي" والـ "تمسخير" وأنا أقول في نفسي: "شدة وتزول"، وأدركتُ أنّ العديد من الناس ينتظرون ضعفك بفارغ الصبر ليصُبوا عليك جحيمَهم ويُسقِطوا أقنعتهم، وأنا في غمرة الحزن إذْ لقيني أحدهم قائلا: "حميد، راهم نشرو الحوار اليوم، بصح ماشي كيما قلت لينا".
تركتُه بكلامه وذهبتُ مسرعا إلى الأنترنت، قمتُ بتحميل الجريدة ورحتُ أتصفحها صفحة صفحة حتى وصلتُ لمكان الحوار، أو دعوني أقول: حتى وصلتُ لمكان "الصدمة".
 المفاجأة
المفاجأةفي ربع عمود لا يتعدى عشرة أسطر أسفل الصفحة، وبخط صغير لا يكاد يُرى بالعين المجردة، كُتب الحوار الذي قضيتُ في تحضيره الساعات الطوال، وأرجوكم لا تسألوني عن الصورة، لأنها لم تُنشر أصلا، وكلما تذكرتُ قصة ربطة العنق أصاب بالاختناق، آه يا عمّار، لو وجدتُك.
قرأتُ ما كتبوه عني في أقل من ثلاثين ثانية، مجازر لغوية، أفكار لم أقلها تماما، بالإضافة إلى خطأ في اسمي واسم مدينتي... مهزلة بكل المقاييس.
التفتّ إلى أعلى الصفحة فإذا مقال طويل كبير مكتوب بالخط العريض: "مجرم يقتل صديقه ويمثّل بجثته" قرأتُ محتوى المقال فإذا هو إثارة في تهويل في تضخيم في كذب في ضحك على الذقون، ويضعون ثلاث صور بارزة كلها من الأنترنت، واحدة لسكين والأخرى لمجرم والأخيرة لطعنة، تمعنتُ جيدا في مقال الجريمة والمقال الذي كُتب عنّي، ثم قلتُ لنفسي في لحظة غضب: "ليتني كنتُ مجرما"
انتهى ملاحظةالقصة خيالية تحاكي أحد المقالات التي وجدتُها في إحدى الجرائد الوطنية، فأردتُ تسليط الضوء على واقع الصحافة المكتوبة
ملاحظةالقصة خيالية تحاكي أحد المقالات التي وجدتُها في إحدى الجرائد الوطنية، فأردتُ تسليط الضوء على واقع الصحافة المكتوبة