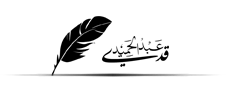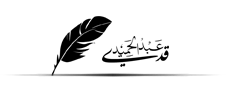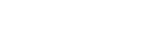من طفولتي الجميلةعدتُ مساءً للمنزل أشعث أغبر، قدماي لم يعترفا يوما بشيء اسمه "حذاء"، ووجهي "أشهبٌ" كعادته إلا مِن بقعة الدسم التي لا تفارق فمي، محطتي الأولى دائما عند دخولي المنزل هو مخزن جدتي "المقدس"، أستعطِفُها كي أحصل على المفتاح من أجل أكل ثلاث "سفّات"، لأنها لا تسمح لي بأكثر من ذلك، فضلا عن كوني "فأر" المنزل، هكذا ينادونني دائما، فأي نقص يسجل على مستوى "المخزن" أو الثلاجة أو المطبخ فأنا المتهم الجاني وبدون محاكمة عادلة، حتى وإن قام بها إخواني فلا مجال للدفاع عن النفس.
بعد أكلي "السفوف" التي "تشفع في المصران" على حد قول جدتي الحكيمة، دخلت للغرفة أين تجلس والدتي وإخوتي، وكلي حماس لمشاهدة الرسوم المتحركة، ومن سوء حظي الذي "لم أُثِر شفقته يوما" ركلتُ كأس شاي دون أن أدري، فتوقف قلبي عن النبض للحظات ولم أستفق إلا والعيون متجهة صوبي أرى غضبها الجامح، فتراجعت قليلا للوراء تحسبا لصواريخ محتملة من صنف "أرض – جو" ثم طأطأت رأسي متظاهرا بالسكينة والوقار أستمع لتوبيخ والدتي الحاد، فحسب إحصائياتها الدقيقة فقد قمتُ بكسر "دزينة" من كؤوس الشاي خلال شهر فقط، دون احتساب الأواني الفخارية والصحون التي قمت بإسقاطها، ولأنّ موسم الأعراس خرج لتوّهِ، فقد سببتُ لها عجزا اقتصاديا إضافيا ما جعلها تضطر لتجديد نصف حظيرتها من الآنية بمواد بلاستيكية مضادة للصدمات.
بعد الكارثة التي سببتُها لم أستطع البقاء في المنزل، فآثرتُ ترك الرسوم حفاظا على سلامتي الجسدية، قررتُ أن ألعب الكرة مع الأصدقاء وبمجرد خروجي من المنزل صادفتُ والدي يحمل قفة ملأى بالخضر والفواكه، توقفتُ عن المشي مستعدا للسؤال الأكثر تداولا في حياتي: "وينهم نعايلك؟"، وجعلها ربي حقا، فقد طرح أبي السؤال كما هو، والصدقَ أقولُ فقد أجبته بنفس الإجابة التي يسمعها عديد المرات في اليوم: "خليتهم في الدار"، أمرَني أبي بالرجوع للمنزل لارتداء الحذاء وتوعدني ككل مرة أنه لن يأخذني للمستشفى إن جُرِحت قدمي.
رجعتُ مسرعا للمنزل ولبست نعلَيْ أخي وخرجتُ من المنزل كالسهم، وما إن ابتعدت قليلا من المنزل حتى نزعت النعلين ووضعتهما في ذراعيّ وواصلتُ طريقي براحة أكبر حتى وصلتُ لـ "ستاد اولاد ....." هي في الحقيقة قطعة أرض قاحلة لها مالكها، استوطنها "أولاد الحومة" جاعلين منها ملعبا لكرة القدم باسمهم، مؤسِّسين شركة لها أسهمها وقيمتها في السوق، حتى أنه بين الفينة والأخرى تنشب حروب شرسة بين "أولاد الحي" على ملكية الملاعب، والغريب في الأمر أن صاحب الأرض ليس طرفا في الحرب!
وصلتُ للملعب وإذ بأصدقائي يحددون لي الفريق الذي أحمِل ألوانه، فقد وصلتُ متأخرا ويبدو أن "القسمة غير عادلة"، وضعتُ نعليْ أخي من يدي ودخلتُ حافيا للملعب مثلي مثل بقية اللاعبين، موقعي في التشكيلة وسط ميدان أو مهاجم، وحظي العاثر أسقطني في فريق ضعيف، أعترف أنني لم أكن أفضل لاعب ولكنني كنت "لا باس بيا"، ومن يدري فلو واصلتُ شغفي بلعب كرة القدم لكنتم اليوم تتفرجون عليّ في القنوات المشفرة بدل قراءتكم لقصة من وراء الشاشة.
يقترب المغرب وتقترب معه نهاية اللعب، فرغم حنكتي الكبيرة في استغلال الظلام لتسجيل "بيطات الضلمة" إلا أن أوامر والدي بحضور صلاة المغرب والحزب اليومي لا يمكن أن تُخالَف، ثم أعتقد أنكم تشاطرونني الرأي بأنه لا فائدة من تسجيل أهداف الفوز تحت جنح الظلام إن كانت ستتبعها ركلات الجزاء في المنزل تحت وقع السياط.
وقبل وقت يسير من نهاية المباراة كانت النتيجة ضدنا بأربعة أهداف لصفر، فقررتُ أن أقوم بهجمة أسطورية أسجل من خلالها هدفا خالدا وأحفظ لفريقي هيبته، وفي أثناء توغلي في دفاع الخصم حان وقت الركلة الأسطورية التي سأختم بها المباراة، ضربت الكرة بكل ما أوتيت من قوة من خلال "بوانتي" حقيقي، ولأن حظي التعيس يعشق مرافقة العظماء فقد تفاجأت بأحدهم وقد نصب لي فخا وحطّ رجله ليُسمَع دويّ "بلوك" جعل الكرة تنفجر، وجعل إبهامي يغرّد من شدة الألم، وانتهت المباراة وقد قامت الشركة بتغريمي مبلغا يعادل ثمن "الكوير المفشوش" وإبهامي انتفخ حتى أصبحت لا أطيق المشي عليه، وفوق كل هذا خسارة مرة قاسية.
لما رجعت للمنزل بادرني أخي بالسؤال عن نعليه، فتذكرتُ حينها أني نسيتهما في الملعب، ولكنني تظاهرت أني لا أعرف وقلت له: "لا تقلق سأساعدك في البحث"، وهو يرمقني بنظرات يتطاير منها الشك الذي يقترب من اليقين أنني أنا الفاعل، وهنا بدأتْ رائحة زكية تعم أرجاء المنزل، نعم فلا شك أن في العشاء ضيوفا، تركتُ أخي المسكين وذهبت لأتوضأ وأتوجه للمسجد منتقيا مكانا استراتيجيا يكون سهل الكشف لوالدي، لأن أي خطإ سيقودني لمحاكمة ظالمة أضطر فيها للتصريح بالسور التي قرأها الإمام مع ذِكر الشخصين الذين صليّا على يميني وشمالي حتى يتأكد أبي من صدقي بعد سؤالهما، وإنْ كانا كبيرَين مصابَين بالزهايمر – لا قدر الله - فالويل لي لأني سأدفع ثمن ذاكرتهما الضعيفة غاليا، هذا لأنني سأعاقَب على عدم الحضور وعلى شهادة الزور.
لدى عودتي من المسجد وجدتُ أخي غاضبا مني لأنه اكتشف أنني من أخذتُ نعليه وأضعتهما، وهددني أنه سيخبر والدي، وجدتُ نفسي في وضعية لا أحسد عليها، ولكنّ أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم، فقلت لأخي: "إن شكوتني لأبي سأفضحك له لأنني شاهدتك البارحة صباحا لم تتوضأ وغسلت وجهك فقط ووضعت جبهتك على التراب وقلتَ له بأنك صليتَ".
أنكر أخي وبدأ في الشجار وتعالت الأصوات، وهنا دخل والدي مع ضيوفه فساد صمت رهيب، ترك أبي الضيوف في غرفة الاستقبال وأتى إلينا يسألنا عن سبب الشجار فبادر أخي يشكوني بأني أضعتُ نعليه وهنا بدأتُ أنا أشكوه ونفّذتُ وعدي بفضحه، وبدأ كل منا يفضح الآخر حتى انتهينا، وهنا قال والدي: "ليذهب الضيوف وسأريكما"، ثم ذهب لضيوفه وتركنا نعدّ الوقت عدًّا كمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.
بعد صلاة العشاء كانت والدتي تحضر الأطباق وأنا أطوف من طبق لآخر وهي تطردني، فرغم القدر القاسي الذي سأتقاسمه مع أخي إلا أنني كنت أعيش اللحظة وفقط، أدخلنا العشاء للضيوف ورحبنا بهم وأكلنا معهم، وبعد الانتهاء أرجعنا الأطباق للمطبخ وقضينا أنا وأخي على ما بقي من أكل الضيوف، ولما هممتُ بالخروج لمستُ إناءً دون قصد فسقط على الأرض وما هي إلا رمشة عين حتى وجدتُ والدتي ماثلة أمامي فقامت بقرصي قرصة أعتقد أن آثارها لا زالت باقية إلى يومنا هذا، ولما شرعتُ في البكاء أمسكَتْ أمي فمي وأنذرتني بعذاب لا قبل لي به إن بدأتُ في الصراخ، كل هذا تم في وضع صامت لعدم إحراج الضيوف ولضمان راحتهم.
بكيتُ من ألم القرصة دموعا بدون صوت، ولما أحسستُ أن الضيوف سيخرجون وفّرت دموعي للقادم الأمرّ، ولكن لا تزال هناك خطة لتأجيل العقاب، فذهبتُ لجدتي وجلست قربها أستعطِفُها من العقاب، وهنا أتى أبي يسأل عني وعن أخي، نهض أخي بكل استسلام، أما أنا فاقتربت من جدتي أكثر، وأنا أعلم أن أبي لن يُلحق بي سوءا مادمت في حمى أمه، فقالت جدتي لأبي مبتسمة: دعه هذه الليلة فيكفيه عقاب واحد، وهكذا نجوت مؤقتا من العقاب، ونجا كذلك أخي.
بعد يوم شاق ومتعب أحسستُ بالنعاس فذهبت إلى فراشي وخلدت للنوم، وفي أحلامي تكررتْ مشاهد اليوم واحدة واحدة، حتى وصلتُ للمشهد الذي شعرت فيه بضرورة الذهاب للمرحاض، فقلت في نفسي: "هذا أفضل من أن أنهض صباحا لتجدني أمي غارقا في بحيرة"، ولما استويتُ وبدأتُ، شعرت بشيء يبلل ملابسي... لقد فعلتها في فراشي، ذهابي للمرحاض كان في الحلم!
نهضتُ من فراشي وإذ بي أرى الأضواء مُنارة ووالدتي فوق رأسي توبخني: "لم يمض على نومك سوى خمس دقائق حتى سمعناك تفعلها"، وما حز في نفسي أكثر هو أن أخي الذي أنقذتُه بفضل حيلتي من العقاب كان يضحك بجنون، أعتقد أن مشاعره مشلولة. قامت أمي بتوبيخ أخي على ضحك الفجور وقالت له: "اللي فاتو عجبو يتعجب"، نظرتُ لها نظرة إكبار على دفاعها عني وقلتُ لها: "كم أنتِ عظيمة يا أمي"، فقامت بقرصي ثانية في نفس موضع القرصة الأولى وقالت لي: "ما زال عندك الوجه لي يتكلم".
 ملاحظة:
ملاحظة: القصة عبارة عن أحداث يوم افتراضي يحاكي جزءا من طفولتي الجميلة