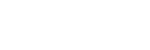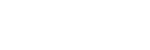حاول
القرشيون في مكة قدر استطاعتهم أن يمنعوا رسول اللهوأصحابه من دخول مكة
لأداء العمرة، وقد دار بين الجانبين مفاوضات كثيرة، وانتهت تلك المفاوضات
بإرسال رسول الله عثمان بن عفان t سفيرًا للمسلمين إلى قريش للتفاوض معهم في أمر دخول المسلمين إلى مكة للعمرة.
وكما علمنا فقد كان
موقف قريش -برغم اعتزازها بالكثرة والقوة- شديدَ الضعف تجاه مطلب المسلمين،
وقد وقفت قريش حائرة تُقدِّم رِجلاً وتؤخِّر أخرى، وترسل الوسطاء الواحد
تلو الآخر، وما استطاعت أن تأخذ قرارًا بحرب المسلمين، مع علمهم أن
الرسولوأصحابه لم يكونوا يحملون غير سلاح المسافر، وليس معهم عُدَّة حرب.
ومع كل هذه
المفارقات بين قوة المسلمين وقوة المشركين، إلا أن المشركين حرصوا تمام
الحرص على إتمام الصلح بينهم وبين المسلمين، وتجنبوا تمامًا أمر القتال،
وقرار الصلح هذا لم يكن بسهل ولا يسير على قريش، وقد أخذ منها الوقت والجهد
الكثير واليوم بعد اليوم، وما زال عثمان بن عفان t في داخل مكة ينتظره.
إشاعة.. ورد فعل
في أثناء انتظار
عثمان بن عفان t قرار قريش، أشيع بين المسلمين أنه ما تأخر إلا لأنه قتل في
مكة، وهذا يُعَدّ أمرًا خطيرًا ومخالفةً جسيمة للأعراف والقوانين، وفيه
إهانة كبيرة جدًّا للدولة التي قُتل رسولها.
وفور وصول هذه
الإشاعة إلى أسماع النبي، تعامل معها بكل جدية وصرامة، فهنا أشيع أن عثمان
بن عفان رسولُ المسلمين إلى قريش قد قُتل، فماذا يكون تصرُّف الدولة
العزيزة التي تدافع عن كرامتها، وترفع رأسها بين الدول تجاه هذا الفعل
المهين؟
لقد جمع رسول الله
المسلمين جميعًا، ثم عقد معهم بيعة هي من أعظم البَيْعات في تاريخ الأرض،
وقد عُرفت في التاريخ بـ (بيعة الشجرة أو بيعة الرضوان)[1].
وقد سميت بيعة
الشجرة؛ لأنها وقعت تحت شجرة عند الحديبية. وسميت بيعة الرضوان؛ لأن
اللهصرح في كتابه الكريم أنه رضي عن هؤلاء الذين قاموا بها، فقال I:
{لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].
بيعة الرضوان
بايع المسلمون الرسول، ولكن على أيِّ شيء بايعوا؟
الصحابة جميعهم قد بايعوا على ألاَّ يفروا، وذلك كما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما[2]،
كما بايع بعض الصحابة على الموت، بل بايع بعضهم على الموت ثلاث مرات كسلمة
بن الأكوع t؛ إذ بايع مرة ثم الثانية فالثالثة، كما جاء أيضًا في صحيح
مسلم[3].
فكانت البيعة جِدُّ
خطيرة حقًّا؛ إذ بايع الجميع على عدم الفرار، أي أنهم سيناجزون القوم،
وسيقاتلون قريشًا، ولن يفروا أبدًا في هذا القتال، وهذا رغم كونهم لا
يحملون إلا سلاح المسافر فقط. وقد بايع جميع الصحابة على هذا إلا واحدًا
فقط هو الجَدُّ بن قيس، وهو -كما ذكرنا سابقًا- كان من المنافقين.
غير أن الغريب أنه
بعد هذه البيعة العظيمة مباشرة جاء عثمان بن عفان t سالمًا لم يصبه شيء،
وقد أخبرهم أن القرشيين قد وافقوا على الصلح، وأنه سيأتي رجل منهم يفاوض
رسول اللهعلى بنود الصلح.
وقد ترتب على هذا أن المسلمين لم يدخلوا في حرب مع المشركين، وقد ظلت بيعتهم كما هي، الأمر الذي يتطلب وقفة مع هذا الحدث الجليل.
بيعة الرضوان في ميزان الإسلام
كان هناك عدة أمور ترتبت على عقد بيعة الرضوان هذه، وكانت ذات أثر ومعنى بالغ عند جميع المسلمين كما يلي:
أولاً: بها خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه:
يقول الله تعالى:
{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ
العَالَمِينَ} [الأنعام: 162]. فكل شيء في حياة المسلم هو لله رب العالمين،
وفي سبيله حتى لحظة الموت، طاعة كاملة لله ولرسوله، وهذا أمر من الصعوبة
بمكان.
فهذه مجموعة من
المسلمين جاءت من المدينة إلى مكة لأداء العمرة، يتسلحون فقط بسلاح المسافر
ولا مدد لهم؛ إذ المدينة على مسافة خمسمائة كيلو متر تقريبًا من هذا
المكان، وكان الطبيعي أنهم إذا قاتلوا المشركين فإنهم جميعًا سيقتلون؛ إذ
إنهم سيقاتلون جيشًا بعدة وعتاد، وفوق ذلك فهو على بُعد خطوات قليلة من
المدد، كما أن قريشًا كان معها الأحابيش والقبائل الحليفة.
في هذه البيعة لم
يفكر واحد من المسلمين في أولاده أو زوجته، لم يفكر أحدهم في تجارته أو في
أعماله، لم يفكر أحدهم بالمرة في حياته، لم يقل أحد منهم أن ظروفه لا تسمح،
بل لم يعقد أحد منهم هذه البيعة حرجًا من رسول الله، أو حرجًا من
المسلمين، إنما عقدوها جميعًا وهم صادقون راغبون، يقول الله I: {لَقَدْ
رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} [الفتح: 18].
فقد اطّلع اللهعلى
قلوب كل من بايع، فعَلِم I أن هذه القلوب جميعها مخلصة مؤمنة، وكان هذا من
الفتح المبين الذي ذكره اللهفي بداية سورة الفتح التي تحدثت عن غزوة
الحديبية أو صلح الحديبية، حيث قال I: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: 1].
فَأَنْ يصرح رب
العالمين بالرضا عن هذه المجموعة الكبيرة من البشر، والتي يبلغ عددها ألف
وأربعمائة مسلم، وهم ما زالوا أحياء على وجه الأرض يُرزقون، لهو -والله- من
الفتح المبين.
وأن تصل مجموعة من
البشر إلى هذا الرقي وهذا الإخلاص وهذا الفقه والفَهْم، وهذا العمل بهذه
الصورة إلى الدرجة التي ترضي رب العالمين I رضاءً تامًّا يعبر عنه في كتابه
الكريم، ونقرؤه في كتابه إلى يوم القيامة، هذا من الفتح المبين.
فكان لهذه البيعة
حقيقةً مكانتُها وقيمتها في الميزان الإسلامي، وقد ظل هؤلاء الصحابة ألف
وأربعمائة صحابي في عُرْف علماء الأمة من أعظم المسلمين درجة وإلى يوم
القيامة، وهذا هو كلام الرسول وشهادته لهم، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر
بن عبد الله أنهخاطبهم يوم الحديبية وقال لهم: "أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرُ
أَهْلِ الأَرْضِ"[4].
فكان هذا -إذن- هو
أول ما ظهر في هذه البيعة، وهو التضحية والبذل والعطاء الكامل من الصحابة
رضوان الله عليهم، وهو خلاصة ما هو مطلوب من المؤمن في دنياه.
ثانيًا: اهتزاز مكة من داخلها:
هذا الموقف الذي
أعلن فيه المسلمون تضحياتهم العظيمة، ورغبتهم الأكيدة في الموت هزَّ مكة من
داخلها هزة عنيفة، فمن ذا الذي يستطيع أن يقاتل قومًا يطلبون الموت؟!
بماذا يهددهم ويخوفهم؟! أبالموت؟! فهذا هو مطلبهم؛ فقد بايعوا على أن
يموتوا وعلى ألا يفروا حتى النهاية، حتى ولو كانوا عُزْلاً أو لم يكن معهم
إلا سلاحٌ بسيط.
وما من شك أن هذا
الموقف قد هزَّ مكة، وجعلها ترضخ للمفاوضات، وهي تريد أن يعود الرسولإلى
المدينة بأي ثمن، حتى وإن انتقص هذا من كرامتهم، وهذا ما سنراه بعد ذلك في
بنود معاهدة الصلح.
وهذا الموقف من قِبل
المسلمين، والذي هو من صفات الجيش المنصور، هو ما عبر عنه خالد بن الوليد t
بعد هذا الحدث بسنوات بكلمات قليلة، قد ذكرها لهرمز ملك الأُبُلّة عند
بدايات فتح فارس، حين قال له: "جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة"[5].
فالجيش الذي يحب الموت من المستحيل أن يُهزم، وهذا درس من أعظم دروس الحديبية، وكان من أجله أن قررت قريش إبرام الصلح بكل ما فيه.
ثالثًا: أخذوا قرار الموت فلم يصابوا بسوء:
وهو أمر غريب حقًّا،
إذ لم يصب المسلمين سوءٌ عندما أخذوا قرار الموت وعدم الفرار، بينما
أصابهم الموت في أُحُد واستشهد منهم سبعون رجلاً، وذلك حين أخذوا قرار
الفرار (قرار الحياة) يوم أُحُد.
وإنه لأمر عجيب،
سبعمائة رجل في أُحد يُقتل منهم سبعون، بينما ألف وأربعمائة في الحديبية لم
يقتل منهم واحد، وهذا هو كلام أبي بكر الصديق t حين قال: "احرص على الموت
توهب لك الحياة"[6].
فالجيش الذي يريد
الموت حقًّا يهب له الله I الحياة، ومعها النصر والتمكين والسيادة، أما
الجيش الذي يريد العيش أيًّا كان نوعه حتى لو كان رخيصًا أو ذليلاً، فهذا
الجيش يكتب الله I عليه الموت.
رابعًا: التصريح بالرضا عن الأحياء:
وهذا أمر مهم جدًّا
ولافت للنظر، فالله I قد صرح بأنه رضي عن أولئك الذين قاموا بالبيعة، مع
أنهم ما زالوا على قيد الحياة، ومن الممكن بعد ذلك أن يرتكبوا ذنوبًا أو
أخطاء.
فإذا كان الله I
يعلم الغيب، ويعلم أن هؤلاء سيفعلون كذا وكذا، إلا أنه من المؤكد أنهم
سيقعون في أخطاء وذلك لكونهم بشرًا، وكل بني آدم خطَّاء، وخير الخطائين
التوابون.
بَيْدَ أننا نفهم من
هذا معنى في غاية الأهمية، وهو أنه من الممكن أن يكون هناك موقف واحد في
حياة المسلم لصالح المسلمين أو لصالح الأمة، يكون من الثقل بحيث إنه لا
يُعدل به ذنبٌ بعد ذلك.
وهذا بالتأكيد ليس دعوة لاقتراف الذنوب، ولكنها دعوة للأعمال الصالحة التي تثقل في ميزان المسلم. ومثل هذا قد رأيناه أكثر من مرة في السيرة النبوية،
كان منه -على سبيل المثال- صنيع عثمان بن عفان t في تبوك -سنتحدث عنه
بالتفصيل بعد ذلك بمشيئة الله- والذي قال عنه رسول اللهيومها: "مَا ضَرَّ
عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمَ"[7].
فكان هناك موقف واحد
في حياة عثمان t لو وضع في كِفَّةٍ ووضعت بقية الذنوب في كفة أخرى، فسترجح
كفة هذا الموقف الكفةَ الأخرى، وبهذا سينجو عثمان t.
وقفة
وهنا نريد أن نقف وقفة ويسأل كلٌّ منا نفسه: هل عندي موقف أعتقد أنه سيكون سببًا لنجاتي يوم القيامة؟
فكلنا يصلي ويصوم،
لكن هل هناك عمل في حياتنا يخدم الأمة الإسلامية، ونستطيع أن نحمله بين
أيدينا يوم القيامة معتقدين تمام الاعتقاد يومها أنه مُنجِّينا من النار؟
فما حدث في بيعة
الرضوان هو عمل واحد لكل صحابي دار في ساعة أو ساعتين من الزمن، لكنه ظل
حدثًا يقتدي به المسلمون ويتعلمون منه، بل ويحفظ في كتاب رب العالمين I
وإلى قيام الساعة، وإننا لنريد لحظات صدق من هذا النوع من الأعمال، والتي
يمكن أن تنجينا في الدنيا والآخرة.